حسنًا، التوتر أقل بكثير هذه المرة. أشعر براحة أكبر في الكتابة هذه المرة، كوني بالفعل أزلتُ الستار عن صندوق (باندورا) الخاص بي. وما أقصده بإزالة الستار هو نشري لتدوينة “هل الصوت واضح؟” وقصة “راكب هاوي” سابقًا على المدونة، واللتان تُعتبران أول نصوص أنشرها إطلاقًا. بعد نشري لتلك النصوص، صرتُ مرتاحًا أكثر في التحدث معك عزيزي القارئ، ولست متأكدًا من السبب وراء ذلك. أهو شعور بأن هذه التدوينة تمثل المرة الثانية التي أحدثك فيها مباشرةً، وأننا لا نحتاج لتبادل عبارات التعارف مرة أخرى؟ أهو شعور بأني فجأةً صرتُ مدوِّنًا “مخضرمًا” ذا خبرة سابقة؟
لا أظن أن السبب مهم، فالمهم في نهاية المطاف أني صرتُ أرتاح في التحدث معك و”الفضفضة” لك.
ماذا عنك عزيزي القارئ؟ هل تشعر بأنك تعرفتَ عليَّ أكثر وصرتَ “تبخصني”؟ بتُّ أتخيل أن كتابتي لهذه التدوينة صارت بالنسبة لك كجلوس صديقين أمام طاولة مقهى، متناولًا أنا في يدي كوب (أمريكانو)، ومتناولًا أنت في يدك كوب (ماتشا) بارد. لم تروق لك المقارنة؟ أتمنى أن يكون السبب هو رفضك لاختياري الإجباري لمشروبك -الذي قد تمتلك تحيزات اجتماعية تجاهه- وليس رفضك لصحبتي اللطيفة.
مررتُ ببضعة أيام مثيرة منذ التدوينة الأولى. ركضتُ نحو حقائبي الهاربة مني على السير المتحرك في المطار، ضَجِرًا من فكرة انتظاري لها لتأخذ دورة كاملة حول المئة والخمسين راكبًا الواقفين أمام السير حتى تعود إليَّ مرة أخرى. ركضتُ حول مربع سكني كامل ساحبًا معي حقيبتي سفر، محاولًا بسذاجة تفادي مطر (فيينا) الغزير الذي كان يحاول إغراقي. لِمَ الركض؟ لأن سائق الأجرة -بدون علم منه ولا مني- أنزلني في الجهة الأخرى من الفندق، ولم أستوعب خطأه الفادح إلا عندما حاولتُ فتح أبواب ثلاثة متاجر مغلقة ظنًّا مني أنه باب الفندق.
ماذا أيضًا؟ قررتُ الذهاب إلى وسط (فيينا) في تمام الساعة العاشرة مساءً، ظنًّا مني أنها ستكون “مزدحمة” و”حية”، وأن (فيينا) ستكون مدينة “مسائية”. في حال لم تقدر على تخمين النتيجة عزيزي القارئ، ظنِّي لم يكن صحيحًا، والنتيجة أني بقيتُ واقفًا وحيدًا في منتصف المدينة لربع ساعة منتظرًا رؤية روح أخرى، لكن انتظاري لم يطُل قبل قراري بالعودة إلى الفندق من الطريق نفسه.
وجدتُ غرابة شديدة في شعور السفر وحيدًا، فما تمرّ لحظات حتى أقول لنفسي مرة أخرى: “أمستوعبٌ أنك تبعد آلاف الكيلومترات عن أي شخص يعرف اسمك حتى؟”، ولا أدري هل يريحني أم يزعجني هذا الشعور. قد يريحني في هذا الشعور فكرة الاستقلالية الكاملة التي تأتي مع العزلة، فلا أجد حولي أي شخص يملك عليَّ مسؤوليات تجاهه، ولا صديق ينتظر مني أن أرافقه اليوم في رحلة أربع ساعات متواصلة في الشارع نفسه قبل الذهاب إلى المطعم نفسه الذي تعشَّينا فيه سبعين مرة سابقة.
لكن يقتلني الهدوء المميت في غرفة الفندق عندما أعود إليها في نهاية يومي، فهذا الهدوء يمنح المساحة لوساوسي أن تستفرد بي وتتحدث معي أكثر من اللازم. تبدأ الأفكار السلبية بالتحكم في جو الغرفة، وفجأةً يخرج كل الهواء من الغرفة وتغدو محاولة التنفس الاستراتيجية الوحيدة التي أملكها. كل تلك الأفكار والمشاعر تتلاشى طبعًا بعد أن أستيقظ في صباح اليوم التالي وأخرج مسرعًا من غرفة الفندق لبدء مهمة استكشاف جديدة.
وقد يزعجني أيضًا في فكرة سفري وحيدًا إلى دولة غريبة، السيناريو الذي يراودني بأنه لو تم دَهْسي في وسط أحد شوارع (فيينا)، كل ما سيراه العابرون وجهٌ بلا هوية، مضطرًا بأن يتم نقل جثتي آلاف الكيلومترات عودةً إلى مدينة (جدة) حتى أحصل على شرف زيارة بعض الأشخاص لقبري والرثاء عليَّ. أخذت التدوينة منعطفًا سلبيًّا في نظرك يا عزيزي؟ حسنًا، لا تقلق سأحاول إبقاء الإيجابية فيها على مستوى أعلى.
لكن بكل جدية، تجربة العزلة لهذه المدة من الوقت أثارت اهتمامي بشدة، فلا أزال أقول لنفسي: “لم أستوعب كم أني أجد نفسي شخصًا حُلْوَ الرفقة، خفيف الطُّرفة، جميل الحكاية والمجلس”. فأتصور أن نفسي هي فعلًا الشخص المثالي لي، وأنها ستكفيني عن كل الناس لبقية عمري، وأني اكتشفتُ جمال نفسي عندما اختفى كل الناس من حولي وسنحت الفرصة لنفسي أن تبدأ حوارًا معي بدون إزعاج أو مقاطعة.
لكن لا أزال أيضًا أتساءل: “متى سأبدأ بالملل من نفسي؟ وتبدأ الحكايات والنقاشات بالنفاد، ويزول الاهتمام، وأبدأ باللجوء إلى تصفح مواقع التواصل عوضًا عن الحديث مع نفسي؟ متى سيبدأ الشك بأني لا أرى نفسي بمثل كمية التقدير التي تصورتُها في بداية هذه العزلة؟ وأبدأ أيضًا بالشك أن نفسي تبادلني هذا الشعور بالملل, وأنها تفكر بإنهاء ما بيننا والتعلق بشخص آخر تشاركه رفقتها وطُرَفها وحكاياتها؟ يبدو هذا السيناريو مألوفًا بشكل غريب.
ذكَّرني هذا الموضوع بكهلٍ وزوجته رأيتُهما خارجَيْن من منزلهما. لمحتُ المشهد وأنا أفطر من مقعدي الكئيب على (البار) الذي دلَّتني عليه النادلة لأني المسافر “الوحيد” الذي لا يستحق طاولة خاصة به مثل بقية المسافرين الذين يدخلون المطعم أزواجًا.

حوَّلتُ بصري عن طبق (الأومليت) بين يديَّ إلى باب البيت القديم التي تطل عليه نافذة (البار)، عندما فُتح الباب فجأة. خرجت العجوز أولًا، ماشيةً بتأنٍّ وهي غاطسة برأسها في حقيبتها القطنية الأنيقة، ومن الواضح أنها تتأكد من وجود جميع أغراضها للمرة العاشرة في آخر دقيقتين. لاحظتُ بعدها الزوج الكهل الذي ظهر من خلف باب المنزل، وأدخل يده من كفِّه حتى مِرْفَقه في داخل جيبه، مُخرِجًا سلسلة مفاتيح أكاد أرى فيها مفاتيح تعود للقرن التاسع عشر، ثم قرَّب السلسلة من عينيه وبدأ بالبحث عن المفتاح المسؤول عن إقفال باب المنزل وحماية جنتهم الأبدية. بعد بحث عميق، عثر الكهل على المفتاح وبدأ بإقفال الباب، ثم رفعت الزوجة رأسها من حقيبتها والتفتت إلى الزوج وقالت له شيئًا بالألمانية لم أفهمه. أجابها الزوج بنبرة شعرتُ أنها تأكيدية لسؤالٍ سألته الزوجة مرارًا في آخر ربع ساعة. فبدا لي أنها سألته إن كان قد أطفأ الإنارة أو فصل المكواة من المقبس أو أخذ نظارة القراءة الخاصة به، فأجاب الزوج بالإيجاب، ولم أدرِ إن قالها صادقًا أم أنه لم يحتمل العودة إلى المنزل بعد إقفال الباب وإعادة طقوس إقفال الباب مرة أخرى. أقفل الزوج الباب أخيرًا وقام باللحاق بزوجته، ثم تناولا يدَيْ بعضهما وبدآ بالمشي بخطوات بدت لهما أنها سريعة، لكنها بدت من مقعدي كخطوات طفل يحاول الجري واللحاق بإخوته. جعلني هذا المشهد الذي استمر لمدة نصف دقيقة -والتي بدت كنصف ساعة- أنسى بالكامل وجبة الإفطار أمامي وأستشعر كمية اللطافة والهدوء الغريب الذي رأيتُه في علاقتهما. وفي تلك النصف دقيقة تلاشت كل أهدافي، وصار هدفي الوحيد أن أحصل على هذا القدر من الهدوء وأكون في نهاية عمري الكهل الذي يبحث عن مفتاح الباب كل يوم في سلسلة مفاتيحه لإغلاق بابه العتيق. ثم سألتُ نفسي: “هل ستكفيني نفسي وعزلتي لأحوز على هذا الهدوء؟ أم سأحتاج أيضًا أن أظفر بإنسانة تدفن رأسها في حقيبتها قبل أن تعيد السؤال نفسه الذي سألتْه خمس مرات في آخر عشر دقائق لكي أحوز على هدوء وطمأنينة هذا الكهل نفسها؟”
حسنًا، أجزم بأني أضجرتُك عزيزي القارئ باسترسالي المبالغ فيه في وصف عزلتي -التي لا أدري إن كانت قد أثارت اهتمامك من عدمه- فدعني أغير الموضوع وأتكلم عن جوانب أخرى من رحلتي إلى مدينة (فيينا).

زرتُ متحف (Kunsthistorisches) المشهور واستمتعتُ باللوحات البديعة العديدة التي يقدمها المتحف، بالرغم من أني ضجرتُ من تكرار مشهد “لا، أبدًا، تفضل، صورتي مو مهمة أصلًا”.
تسأل ما هذا المشهد؟ هذا المشهد الذي يحدث داخل المتحف عندما يسقط بصرك على لوحة فاتنة أو زخارف بديعة وتقرر أن تلتقط صورة لها وتضيفها إلى باقي التقاطاتك التي لن تراها أي نفس وتبقى عبئًا على ذاكرة هاتفك حتى تستبدله بهاتف آخر. تمسك هاتفك بكلتا يديك وتصوِّبه نحو هدفك، مركِّزًا بعينيك على الأبعاد والقياسات، وكأن لجنة من سبعة مصورين محترفين سيراجعون الصورة ويقيِّمونها من بعدك. وأخيرًا، في اللحظة التي تبدو فيها التقاطتك مثالية، وتقرر بأن تضغط الزناد على تحفتك البصرية، تبصر فجأةً ساقًا غريبة تتسلل إلى إطار الصورة بخطوة للأمام، ثم تعود خطوة للخلف بعد ما استوعب صاحب الساق اللعينة أنه أفسد التقاطتك. ترفع بصرك من هاتفك وتحوِّله نحو الشخص الذي أفسد صورتك مع رغبة جامحة بأن تضغط الزناد بسلاحٍ موجَّه نحو رأسه -ولا أقصد الكاميرا هذه المرة- فتجده -في أغلب الحالات- سائحًا كهلًا مرتديًا ابتسامة خجولة بريئة، يحرِّك يديه بإيماءات تعني في الغالب “تفضل خُذ الصورة، ما قصدت أخربها عليك”. وكونك إنسانًا لطيفًا عزيزي القارئ، يكون ردُّك عليه أيضًا إيماءً موجَّهًا نحو الممر أمامك قاصدًا به أن تقول “لا، أبدًا، تفضل، صورتي مو مهمة أصلًا”. فهذا كان المشهد المضجر الذي قصدتُه، والذي سيصادفك كثيرًا عند زيارتك للمتاحف. كانت هذه أول زيارة لمتحف وحيدًا، واعتبرتُها تغييرًا جميلًا بأن تتأمل الرسومات بدون شخص بجانبك يطلق عليها دعابات وتشبيهات مبتذلة تفسد تأملك بالكامل. الآن وحيدًا أقدر على تأمل التحفة أمامي، أستشعر رسائلها، ألمس معانيها، أحاول استيعاب أبعادها، ثم أطلق دعاباتي المبتذلة الخاصة وأرويها لنفسي -التي دائمًا تجدها مضحكة- وأذهب نحو الرسمة التالية لأعيد الخطوات نفسها.
وبما أننا نتحدث عن مدينة (فيينا)، قد يبدو الوقت مناسبًا لمناقشة فيلم (Before Sunrise) الذي تابعتُه مؤخرًا قبل ترحالي، فاسمح لي أن أناقش الفيلم، ورأيي فيه، وتأثيره على تجربتي مع المدينة.

فيلم (Before Sunrise):
سعيد بأني تابعتُ الفيلم قبل مجيئي إلى (فيينا)، فمتابعتي أعطتني منظورًا آخر خلال تجوالي في المدينة. كلما مررتُ بجانب موقع تم استخدامه في الفيلم، أبدأ بتخيُّل (جيسي) و(سيلين) جالسَيْن أمامي يتحدثان، (جيسي) بغرابته وثرثرته، و(سيلين) برقتها وعذوبتها في الكلام، بالرغم من أن لها خصوصًا غرابة تزيد من غرابة (جيسي) أكثر. شدَّني الهدوء القاتم طوال الفيلم، فغياب أي موسيقى في الخلفية زاد من عفوية الحوارات التي كانت عفوية وحقيقية منذ المشهد الأول بين هاتين الشخصيتين. كنتُ أشعر في كل حوار قيِّم يدور بينهما أني جزء من هذه المحادثة، راغبًا في مقاطعتهما وإبداء رأيي قبل أن توقفني الشاشة القائمة بيننا. كانت في هذه الليلة نقاوة لم أعتدها من باقي الأفلام العاطفية التي تابعتُها من قبل، فمن البداية يتضح لك أن أساس العلاقة بين (جيسي) و(سيلين) هو إعجابهما بعقلَيْ بعضهما والفضول الذي يتملكهما تجاه بعضهما، بالإضافة إلى البيئة الصحية التي يوفرانها لبعضهما والتي تخلو من أي حُكْم أو اتهامات تجاه طبيعة شخصيتيهما اللتين يعتبرهما مجتمعهما غريبتين.
في الفيلم، تتحدث (سيلين) عن تجربة شعرتُ بأنها لامستني شخصيًّا، وكانت هذه التجربة عندما ذهبت إلى مدينة (رواسو) في صغرها. في وسط إقامتها في تلك المدينة، شعرت بعزلة شديدة عن باقي العالم وعاداتها المعتادة. كان هذا الشعور في الغالب بسبب أن التلفاز كان بلغة لا تفهمها، وغياب وسائل ترفيه أخرى لأن المدينة كانت لا تزال تحت حكم شيوعي قاسٍ. أجبرتها هذه العوامل على العزلة والكتابة والتحدث إلى نفسها كوسيلة ترفيه، مما أكسبها راحة البال وأجبر عالمها أن يمشي ببطء، وأبعدها عن الشعور المُلِحّ بأن تكون في مكان آخر وتلحق بدوران العالم السريع.
وبعد الأيام الأربعة التي قضيتُها بنفسي في (فيينا)، تأكدتُ بأني كسبتُ هذا الشعور بالمثل. فجأةً صار اليوم طويلًا، وبدأتُ أشعر بسلام داخلي وذهن خالٍ من جداول المهام اليومية والواجبات والالتزامات. بال مرتاح من جرعات وسائل التواصل الاجتماعي والجري وراء هدف أو مكان آخر يجب أن أتواجد فيه. أودُّ أن يلازمني هذا الشعور للأبد، لكن للأسف أدري بأنه سيزول أول ما أضع قدمي عودةً إلى الديار.
عودة إلى الفيلم، فبعد انتهائي من متابعة الجزء الأول -الذي وقعتُ في غرامه- استوعبتُ فقط وقتها أن هناك جزءًا ثانيًا وثالثًا. رغم استغرابي وشكوكي حول جودة باقي الثلاثية ووجودها من الأساس، مع ترددي المستمر لمتابعتها، تغلَّب فضولي في النهاية على رغبتي بأن أصون نقاوة تجربة الفيلم الأول. السؤال الذي كان يدور في بالي خلال متابعتي للجزأين الثاني والثالث هو: “ليش؟!” الفكرة من قصة الفيلم الأول هي سحب كل الأهمية من سؤال “هل سيتقابلان مرة أخرى؟” والتركيز على تقدير هذه الليلة التي سيقضيانها معًا “قبل شروق الشمس”، فلماذا نرى أي استمرار للقصة بعد هذه الليلة؟! لن أذكر تفاصيل أخرى في حال كنتَ تهدف لمشاهدة الثلاثية عزيزي القارئ، فخُذ راحتك في مشاهدتها ثم العودة لسماع باقي هَذري.
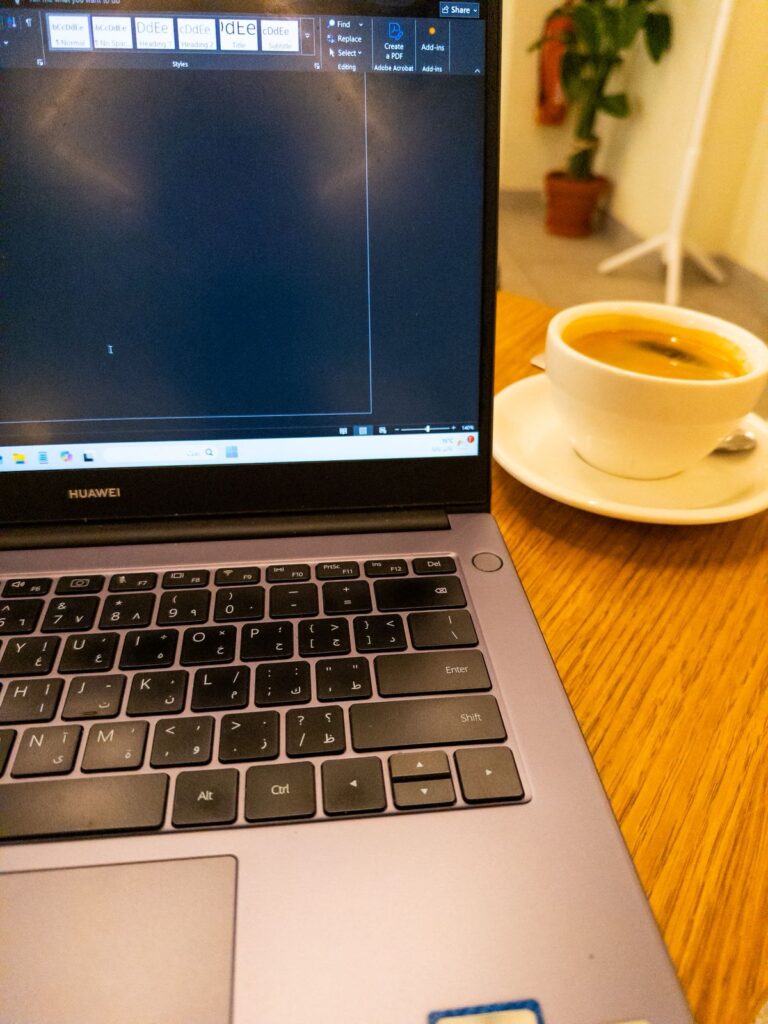
لأعطيك نبذة عن مكاني الحالي في كتابة هذه التدوينة، أنا أجلس الآن في تمام الساعة الثامنة مساءً في مقهى لطيف يبعد خمس دقائق عن الفندق، منتظرًا أن يتملكني النوم حتى أعود وأنام وأستيقظ للحاق برحلتي إلى مدينة (براغ). في نهاية الأيام الأربعة اللطيفة في مدينة (فيينا)، أستطيع القول بأنها جيدة لكن أقل من توقعاتي. توقعتُ منها وجهات سياحية وتاريخية أكثر مع لمسة ثقافية أكبر، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهٍ بجودة أعلى، لكن خذلتني بعض الشيء من هذه النواحي.
هل ندمتُ بأني زرتُها؟ لا، فأعتبرها تجربة لطيفة.
هل سأزورها مرة أخرى؟ أيضًا لا، لأن الأمر يتطلب أكثر من مدينة لطيفة لجذبي لزيارة أخرى. لكن حاليًّا أتطلع إلى (براغ) بآمال أكبر وحماس أشد، فهي وجهتي الأساسية منذ البداية.
حسنًا، أرى يا عزيزي القارئ بأني سرقتُ من وقتك، وثرثرتُ عليك بما فيه الكفاية. ستكون المرة القادمة التي أتحدث معك فيها في الغالب تدوينتي حول مدينة (براغ) التي أتمنى بشدة أن تذهلني مثلما أتصور. أم سأنشر قبلها قصة قصيرة أخرى؟ لا أدري صراحةً، يبدو أني سأترك القرار لمزاجي حينها، لكن أتمنى في كل الحالات أن أجدك حينها جالسًا قِبالي على الطاولة، متناولًا في يدك مشروبك الذي أُوعِدُك بأن أسمح لك باختياره المرة القادمة…

اترك تعليقاً