لِمَ صار الموضوع مربكًا الآن؟ ملامسةُ مفاتيح الكيبورد تشابه إحساسَ ملامسة حديد فرنٍ مشتعل، كلما حاولتُ لمسها استشعرتُ موجةً حارقة تدغدغ أناملي، تمنعني من كتابة أي كلمة غير مثالية. لِمَ هذا الخوف المفاجئ؟ كنتُ من قبل أرمي أصابعي على الكيبورد غيرَ مبالٍ بالنتيجة، قائلًا “لا تشيل هم، كلها خربشات، مَن بيشوفها يعني؟!”. لكن الآن، عقلي يعمل بشكلٍ يفوق مساحةَ طاقته الاستيعابية المعتادة (والتي لا تُعَدُّ مساحةً هائلة بصراحة) للتأكد من أن كل ما يُكتَب مثاليٌّ نحويًا وسرديًا ولفظيًا وأخلاقيًا، بالإضافة إلى 24 معيارًا آخر لا أدري مَن يُلزمني بالمحافظة عليها في وسط كتابتي لتدوينةٍ من الغالب ألّا يقرأها سوى ثلاثةٍ من أصدقائي، واحدٌ منهم سيقرأها بصدرٍ رحبٍ بينما يُجاملني الاثنان الآخران ويُهملان قراءةَ أي “خربشات” أنشرها لاحقًا (لو نشرتُها بالفعل).
أهو شعورٌ بفقداني للسيطرة على مَن يقرأ ما أكتب؟ فقد قرأ عدةُ أشخاصٍ ما كتبتُ من قبل (حسنًا، شخصان فقط وليس عدة)، وكانت العملية تتضمن تحليلًا نفسيًا للشخص الماثل أمامي، واختبارًا له في مدى انفتاحه وإبداعه، والأهم من ذلك كله: ولائه! فآخر ما أريده هو رؤيةُ نصٍّ من كتابتي يُعرَض على برج الشاشة في طريق الملك أمام عائلتي وجميع معارفي، مع وجود الشخص الذي وثقتُ فيه بأهم أسراري أسفل البرج، رافعًا سبابتَه الحقيرة تجاه نصي المكتوب صارخًا: “شايفين الهطف إيش كتب!”. لكن الآن، وبشكلٍ مباغت، أنا مَن حكمتُ على نفسي بهذه الفضيحة المحتملة عندما بدأتُ هذه المدونة. الآن رُفِعَت كل الحواجز، وصار للكل الحقُّ في قراءة ما أكتب، ولا أملك القدرةَ على وضع أيٍّ منكم تحت اختباراتي التافهة.
صراحةً، لا أعرف حتى ما السببُ من بدء هذه المدونة، فما الفائدة التي سينتفع بها مَن يقرأ محتواها؟ هل سيزداد حكمةً من قراءة آرائي؟ هل سيستمتع بقراءة نكاتي السمجة؟ لِمَ لا أُغلق الصفحةَ الآن وأنسى الفكرة وأعود لكتابة نصوصٍ حُكِمَ عليها أن تبقى على سطح المكتب؟ لا أملك الإجابةَ عن أيٍّ من هذه الأسئلة صراحةً، لكن ما أعرفه هو أني سأُقدِم على هذه التجربة وأرى نتيجتها.
شعورٌ غريب حقًا، فالشخص الذي يقرأ الآن قد يكون أحدَ أصدقائي الذين لعبتُ معهم “بادل” الجمعة الماضية، أو قد يكون شخصًا غريبًا لا يعرف اسمي حتى. لو أنت أحد أصدقائي، فأظن أني لا أقدر على قول إلا أني سأراك الجمعة القادمة، وحينها ستُخبرني عن رأيك الأدبي والإبداعي حول هذه المدونة (أو تتخذها ذخيرةَ استهزاءٍ تُطلقها نحوي كلَّ 5 دقائق لتُخبرني كم أني “متهيأ” وسخيف). وإذا كانت هذه الأعينُ الجميلة القارئة غريبةً عني تمامًا، فأ… هممم، لا أدري ما المفترض مني فعله صراحةً. هل أُعرِّف عن نفسي؟ يبدو أنه أكثر فعلٍ لائقٍ في هذه الحالة. حسنًا، سأحاول فعل ذلك، لكن أرجو منك الاحتفاظَ بأي نقدٍ أو ملاحظات نظرًا لغرابة الموقف الواضحة، فقد اعتدتُ على التعريف عن نفسي أمام شخصٍ يقدر على الرد والتفاعل مع نكاتي السخيفة. أولًا، أخبرني بالقليل عن نفسك عزيزي القارئ؟ هل تعتبر نفسَك شخصًا شديدَ النقد؟ هاه؟ أتمنى ألّا تكون هذه هي الحقيقة، فأعدك أنك ستجد الكثيرَ من المحتوى القابل للنقد الشديد على هذه المدونة، وآخر ما أحتاجه حاليًا قاضٍ يضرب مطرقتَه عند قراءة كل سطرٍ من أسطري الرديئة العديدة.
حسنًا، سأبدأ. عكس استنتاجاتك من قراءة اسم المدونة، اسمي ليس (بدر) أو (البدر)، بل اسمي هو (عبدالله). (البدر) هو اسمي الأخير الذي قررتُ أنه اسمٌ ملائمٌ أكثر للمدونة. لِمَ اخترتُه؟ اخترتُه لأن (البدر) يمثل آخرَ مراحل اكتمال القمر، وهذه المدونة تشكّل بالنسبة لي آخرَ مراحل اكتمال النص الإبداعي الذي شكّلتْه يداي، فهكذا أكون رسمتُ خطًا واضحًا مستقيمًا بين جمال القمر وجمال الكتابة الإبداعية في توسيع حدود التفكير وأيضًا… أتمنى بحقٍّ أنك لم تُصدِّق سببي الاستعلائي المزيف، ففي الحقيقة، السببُ هو أني لم أقدر على ابتكار اسمٍ إبداعيٍّ مميزٍ للمدونة يُعطيك الإيحاءَ، عزيزي القارئ، أنني كاتبٌ موهوبٌ خارقُ الذكاء، فقررتُ أن أُسمّيها على اسمي الأخير. أنصحك بأن تكون شديدَ الانتباه معي، عزيزي القارئ، فهذه لن تكون المرةَ الأخيرة التي ستراني فيها أحاول تبريرَ أفعالي اللاسببية بمبرراتٍ حكيمةٍ مزيفة.
أُحبُّ الكتابة رغم أني أُصوِّب فوهةَ مسدسٍ نحو رأسي لأُجبِر نفسي على ممارستها. أهوى متابعةَ الأفلام بغض النظر عن أني أجلس لمتابعة فيلمٍ مرةً كلَّ شهرين، ثم أقوم بإعادة فيلمٍ للمرة الخامسة بدلًا من أن أُفرِجَ عن أحد المساجين المقيدين في قائمة أفلامي التي تستمر بالاتساع. أعشق ألعابَ الفيديو، لكن لا أستطيع إخبارك متى كانت آخرُ مرةٍ خرج فيها جهازُ (البلايستيشن) من خزانتي. أستمتع بسماع الموسيقى بجميع أنواعها، لكن أحدَ أصدقائي لا يكفُّ عن تذكيري بأن الأغاني الأربع التي أُشغّلها في سيارته هي نفسُها الأغاني الأربع التي أسمعها منذ تعرّفنا قبل خمس سنوات. ليتني أعرف السببَ الذي يُصعِّب ممارسةَ هواياتي التي أستلذُّ بممارستها واستكشاف جوانبها المختلفة، فيبدو أني أُطبِّق مقولة “الجهل نعمة” بشكلٍ خاطئ من هذه الناحية.
أتمنى أن هذه كانت مقدمةً تعريفيةً كافية لك، عزيزي القارئ، وإذا لم تكن كافية، فلا تقلق، فستتعلم حقائق أخرى غريبة عني مع مرور الوقت.
لأُعطيك نبذةً عن مكاني الحالي، فأنا أكتب هذه التدوينة من كرسي صالة انتظارٍ في المطار، بينما أنتظر موعدَ فتح بوابة رحلتي إلى (فيينا). انضباطي وحذري المبالَغ فيهما يأتيان بي في العادة إلى وقوفي أمام بوابة رحلتي قبل فتحها بساعتين، وبحثي الأبدي عن نشاطٍ يملأ ملَلَ الانتظار، وقد يكون ذلك أحدَ أسبابي للكتابة في هذا الوقت. والآن، لأُعطيك نبذةً عن شعوري الحالي، فأنا أشعر بقليلٍ من التوتر والحذر كونها المرةَ الأولى التي أسافر فيها وحدي، ولكن أشعر أيضًا بالكثير من الاسترخاء والطمأنينة لمعرفة أني سأسافر وحدي. قد وضعتُ مؤخرًا (بعد الكثير من التجارب) قيمةً كبيرة للترحال بدون صُحبة، واستوعبتُ أن حريةَ اختيار المكان والتوقيت رفاهيةٌ لا تُقدَّر بثمن، بالإضافة إلى ميزة التأمل دون وجود صوتٍ مزعجٍ بجانب أذني يُفسد محاولتي لابتكار معانٍ عميقةٍ غير منطقية سأحاول استخراجها من رسمة الجدار التي سأراها بينما ننتظر سيارةَ الأجرة. شكرًا يا رفاقَ الرحلة، لكن صوتي الداخلي مزعجٌ بما فيه الكفاية ولا يحتاج مساعدةً إضافية. أُؤمن بحقٍّ أن غيابَ الأصوات المزعجة (رفاق الرحلة) من حولي هو ما أشعل فجأةً الرغبةَ الجامحة الغريبة لبدء هذه المدونة، فيبدو أن عقلي سَئِمَ من صوته الداخلي المزعج، وقرر أنه يُرسله عليك، عزيزي القارئ، لتتعذب (أو تستمتع) به.
حسنًا، ماذا أيضًا؟ أكملتُ للتو خلال انتظاري رحلتي (التي تبدو أنها غير قادمة) فيلم The Usual Suspects الذي كان يتصدّر قائمةَ متابعتي لفترةٍ طويلة.

أعشق أجواءَ أفلام التسعينات، فرغم اختلافها، تعثر على نقاطٍ متشابهة تجمعها. الاعتمادُ الكبير على صوت راوٍ يسرد القصة، الموسيقى الهادئة، الاجتماعات في مطاعم الإفطار، هوس تدخين السجائر حتى لو كانت الشخصية طفلةً ذات أربع سنوات، جميعُها عواملُ مشتركة لاحظتُها بين الكثير من الأفلام التي تابعتُها ولطالما جعلتني أشعر بالاسترخاء بشكلٍ غريب بغض النظر عن حبكة القصة وشخصياتها. لا يختلف هذا الفيلم في استعراض أغلب هذه العوامل، بالإضافة إلى موجة الغموض والتوتر التي يضربك بها الفيلم منذ البداية. أكاد أُصنِّف مشهد The Lineup الشهير بالعبقرية، فهالةُ الملل والسخرية التي وضعها المجرمون في المشهد أوصلت الرسالتين الواضحتين اللتين كان مُرادًا إيصالُهما: معرفة المجرمين لبعضهم، وكون وجودهم في مركز الشرطة حالةً اعتيادية. أستطيع أن أُصنِّف الفيلمَ عمومًا تحت مسمى “متابعة لطيفة” بالنسبة لي (وهو مسمًى قد يختلف معي أغلبُ مَن تابعه نظرًا لطبيعة محتواه).
–
أظن أن هذه كميةٌ كافية بالنسبة لأول تدوينة. أريدك أن تتأكد، عزيزي القارئ، أن السببَ الوحيد وراء توقفي عند هذا الحد هو إيماني الكامل بأن هذه الكمية كافية، وأرجو ألّا تُفكِّر أن السبب هو اقتراب موعد فتح بوابة الرحلة التي (بسبب حذري الشديد) سأجري نحوها خوفًا من أن تفوتَ الرحلة، فهذه الصورة لا تتناسب مع شخصية كاتبٍ رزينٍ قرر أن يبدأ مدونةً من كرسي مطار.
وبمناسبة حديثنا عن الحذر في المطارات والتأخر على الرحلات، تذكرتُ قصةً لطيفة قد كتبتُها وتحصل أحداثُها في المطار. قد أنشرها بعد هذه التدوينة بقليل. لكن أرجو، عزيزي القارئ، ألّا تُشارك ظنَّ الشخصين اللذَيْن قاموا بقراءة هذه القصة بأن شخصيةَ الراوي تُمثّلني، وأني أتخذ شخصيةَ الراوي في قصصي قناعًا أُجسِّد نفسي به على شكل شخصياتٍ خيالية، فأعدك أني لستُ بغرابة شخصياتي. أتمنى ذلك حقًا…
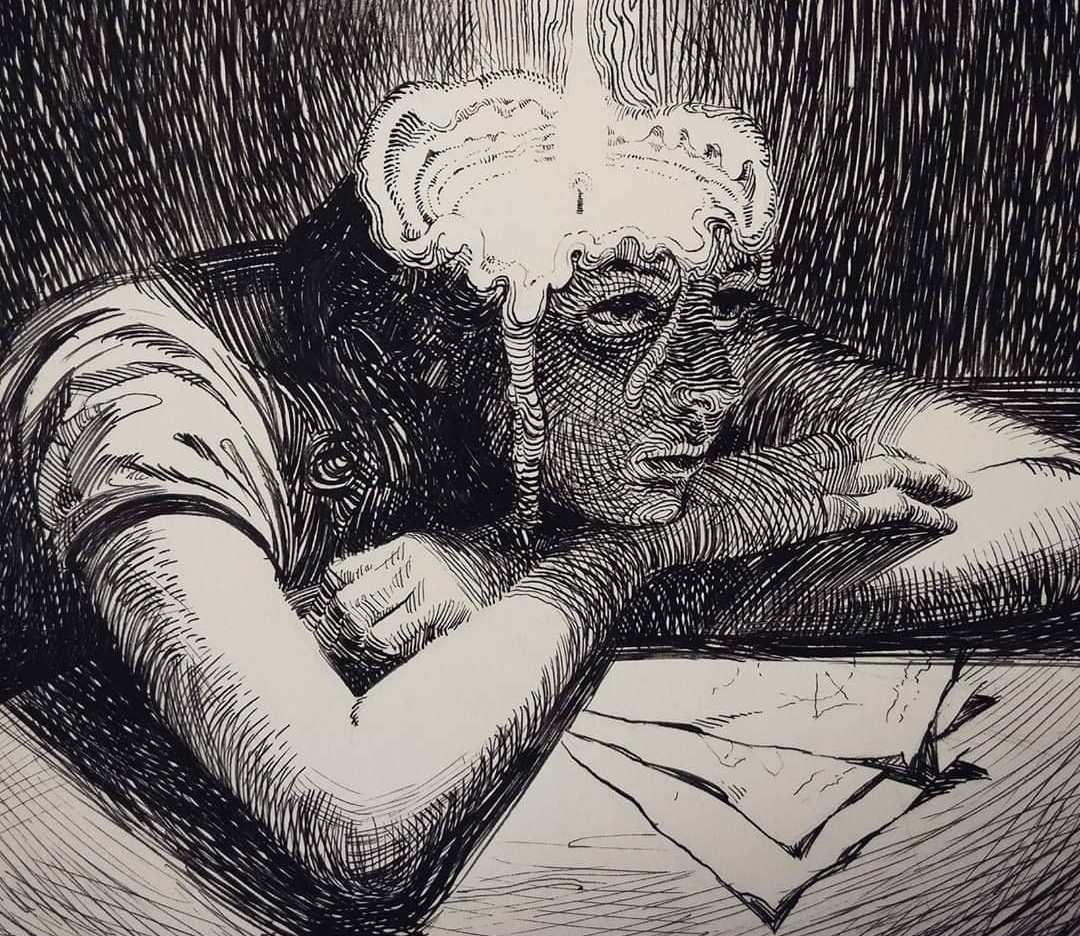
اترك تعليقاً